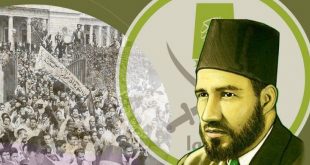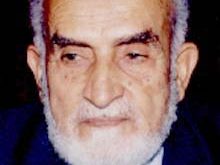الافتتاحية: الآيات39- 43 من سورة الشورى
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشورى:39- 43).
قال الإمام أبو السعود العمادي (898 – 982هـ) رحمه الله: “﴿والذين إِذَا أَصَابَهُمُ البغى هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾ أي ينتقمونَ ممَّنْ بَغَى عليهِم، وهو وصفٌ لهم بالشجاعةِ بعدَ وصفِهم بسائرِ مُهمَّاتِ الفضائلِ وهَذَا لا ينافِي وصفَهُم بالغُفرانِ فإنَّ كلاًّ منهما فضيلةٌ محمودةٌ في موقعِ نفسهِ ورذيلةٌ مذمومةٌ في موقعِ صاحبهِ فإنَّ الحِلْمَ عن العاجز وعن الكرام محمودٌ أما الحلم عن المتغلب وعن اللثام فمذمومٌ لأنَّه إغراءٌ على البَغِي وعليهِ قولُ مَنْ قالَ: إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَه … وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمرَّدَاً … فَوَضْعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيفِ بالعُلا … مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى. ﴿وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا﴾ بيانٌ لكونِ الانتصارِ من الخصالِ الحميدةِ مع كونِه في نفسِه إساءةً إلى الغيرِ بالإشارةِ إلى أنَّ البادئ هُو الذي فعلَهُ لنفسهِ، وفيه تنبيهٌ على حُرْمةِ التعدِّي. وإطلاقُ السيئةِ على الثانيةِ لأنَّها تسوءُ مَنْ نزلتْ بهِ ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ عنِ المسيءِ إليهِ ﴿وَأَصْلَحَ﴾ بينَهُ وبينَ مَنْ يعاديهِ بالعفوِ والإغضاءِ ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى الله﴾ عِدَةٌ مُبهمةٌ منبئةٌ عن عظمِ شأنِ الموعودِ وخُروجِه عن الحدِّ المعهودِ. ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظالمين﴾ البادئينَ بالسيئةِ والمعتدين في الانتقامِ. ﴿وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي بعدَ ما ظُلِمَ ﴿فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مّن سَبِيلٍ﴾ بالمُعَاتبةِ أو المُعَاقبةِ ﴿إِنَّمَا السبيل عَلَى الذين يَظْلِمُونَ الناس﴾ يبتدئونَهُم بالإضرارِ أوْ يعتدونَ في الانتقامِ ﴿وَيَبْغُونَ فِى الأرض بِغَيْرِ الحق﴾ أيْ يتكبرونَ فيَها تجبُّراً وفساداً ﴿أولئك﴾ أى الموصوفونَ بما ذُكِرَ من الظُّلمِ والبغيِ بغيرِ الحقِّ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسببِ ظُلمهم وبغيِهم. ﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ على الأذَى ﴿وَغَفَرَ﴾ لِمَنْ ظلمَهُ وَلم ينتصرْ وفوَّضَ أمرَهْ إلى الله تعالى ﴿إن ذَلِكَ﴾ الذي ذُكِرَ مِنَ الصبرِ والمغفرةِ ﴿لَمِنْ عَزْمِ الأمور﴾ وهَذا في الموادِّ التي لا يُؤدِّي العفوُ إلى الشرِّ”( أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج8، بتصرف).
يقول صاحب الظلال رحمه الله: “وذكر صفة الانتصار من البغي، وعدم الخضوع للظلم في القرآن المكي ذو دلالة خاصة؛ فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة بالله… والدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية، وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق. فهناك اعتبارات مهمة اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة. مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة المسلمة: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة: ﴿وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾. فهذا هو الأصل في الجزاء كي لا يتبجح الشر ويطغى، حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ، وإصلاح الجماعة من الأحقاد. وهو استثناء من تلك القاعدة. والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة. فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء. فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجئ ضعفا يخجل ويستحيي. والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو. فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا. وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز. فليس له ثمة وجود. وهو شر يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه، وينشر في الأرض الفساد! ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ وهذا توكيد للقاعدة الأولى: ﴿وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ من ناحية. وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها. وعدم تجاوز الحد في الاعتداء، من ناحية أخرى.
وتوكيد آخر أكثر تفصيلا:﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ فالذي ينتصر بعد ظلمه، ويجزي السيئة بالسيئة، ولا يعتدي، ليس عليه من جناح. وهو يزاول حقه المشروع. فما لأحد عليه من سلطان. ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد. إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذين يظلمون الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه. والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم. ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية، وعند المقدرة على الدفع وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ، ومن الضعف والذل، ومن الجور والبغي. وتعلقها بالله ورضاه في كل حال. وتجعل الصبرزاد الرحلة الأصيل”(سيد قطب، فى ظلال القرآن، بتصرف).
دروس مستفادة من الآيات:
- العفو عند المقدرة، وعلى من يستحق العفو ولا يسئ فهمه خلق إسلامى رفيع.
- صفح العاجز ليس له قيمة تربوية، ولا يؤدى إلى إصلاح المعتدى بل يغريه بمزيد من العدوان.
- …………………………………………………أذكر دروساً أخرى.
تغليب نفسية التغافر:
هذا النور من أنوار الفطنة التى تبدد ظلمات الفتنة أوقده الزاهد ابن السماك واعظ هارون الرشيد لما قال أحد أصدقائه: “الميعاد بيني وبينك غدًا نتعاتب”(ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج2، ص18) ؛ كأنها كانت هفوة من ابن السماك أو زلة تعكر لها قلب صديقه. فقال له ابن السماك رحمه الله تعالى: “بل بيني وبينك غدًا نتغافر”(ابن المبارك، الزهد، ص 485). وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب، ملؤه فقه وواقعية، يشير إلى وجود قلب وراء هذا اللسان يلذعه واقع المسلمين، وتؤلمه أسباب تفرقهم. فلماذا التعاتب المكفهر بين الإخوان؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصومًا. أليس التغافر أولى وأطهر وأبرد للقلب؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي هذا. وأنوار الفطنة هذه هي: الكواكب الدراري في سماء الدعوة، تزداد بريقا ولمعانًا كلما زاد الظلام لتزيل وحشة المنفرد وتهدي التائه الطريق. أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ أو ليس عبوس التعاتب تعكيرا تصطاد الفتن فيه كيف تشاء؟ بلي والله. ولقد كان شاعر أسبق من دعاة يدعون الفقه، فراح يمرح ويتغنى:
| من اليوم تعارفنا | ***** | ونطوي ما جرى منا |
| فلا كان ولا صــار | ***** | ولا قلتم ولا قلنـــــــــــــــــــا |
وللتغافر الذي أصر عليه ابن السماك أهمية خاصة ، فان الكثير من حوادث نكوص الدعاة ترجع إلى فلتة لسان أو هفوة تعامل لم يغتفروها، والغفران منهم قريب. أو إلى ظن يتوهمون معه حصول تعد تجاههم أو تقصير، وتمحيص الأخبار أو طلب التعليل منهم أقرب. ولو أنهم عتبوا بلسان خفيض من غير استفزاز لكان خيرًا لهم، ولوجدوا من يثني على طيبهم كثناء الشاعر على أصحابه حين أسر عتبهم قلبه فقال:
| عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم: | ***** | أذلك عتب أم رضى وتودد |
وأظهر من ذلك خيرًا لو قدم المستعتب بين يدي عتبه مقدمة تفسير، فيطمئن صاحبه أنها جلسة تصارح وتغافر، لا معركة تناحر، وأنه يريد أن يفرغ ما في صدره أمام كفؤ له وحبيب، ترويحا للقلوب، وقطعا لمحاولات الشيطان، لا التماسا لسبب هجر، ولا تفكيرًا باتهام. ثم كم هي إيمانية هذه الجلسة، وكم روحانيتها لو ختما بخاتمة ابتسام يقول معه لأخي:
| قد قضينا لبانة من عتاب | ***** | وجميل تعاتب الأكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء |
| ومع العتب والعتاب فــــــــإني | ***** | حاضر الصفح واسع الإعفاء |
فهو تعاتب أحباب، يؤتي لجماله، وإكرامًا للذي يتوجه إليه العتاب، ليس فيه نوع انتصار للنفس، وقبول العذر بعده يكون أدعى وآكد وأحرى بالتقديم. وهذا هو المهم.
| فعذرك مبسوط لدينا مقـــــــــــــــــدم | ***** | وودك مقبول بأهل ومرحـــــــــــب |
| ولست بتقليب اللسان مصارما | ***** | خليلي إذا ما القلب لم يتقلب |
المهم أن القلب لم يتقلب تقلبا دنيويا تحركه الأهواء، وإنما كان يعتقد ما تمليه مصالح الدعوة فيصيب ويأتي الخطأ، ولاجتهاده المصيب أجر بعد أجر، وأما الخطأ فينتظره تغافر بين الإخوان، وغفران من الله أكبر.
التقوى في الغضب الهاجم:
فلا يتكلم إلا حقاً وصدقاً، إذ “يروي أن الفتنة لما وقعت قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى” فهي دواء عام يوصف لكل أعراض الفتن، ولكن خصص بكر بن عبيد الله المزني مذهبين من مذاهب التقوى المتعددة لأصحاب الدرجات العالية، فقال: “لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعم، وتقي الغضب” (عبد القادر الكيلاني،الغنية،ج1، ص143). فالداعية المرتقي لا يكمل إلا بأن يكون غضبه لله، فإن كان: وصل إلى قمة أحمد بن حنبل، وشاركه في الفخر باعتلائها، فإنه كان: “يغضب لله ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها، فإذا كان في أمر من الدين: اشتد غضبه حتى كأنه ليس هو”( مناقب أحمد، ص 218). وإنما تتحقق هذه الصورة بإلجام اللسان، فلا يدعه حرًا، وازنًا كل كلمة يفوه بها، ألا يتهم بريئا أو يحتج بظن مجرد أو يستنجد بسخرية وتنابز، فيقطع المحسن إحسانه بسببه، ويعتزل العزيز. وذو التجربة يعرف ما يكمن في الكلام وطبائع نبراته من إمكانات الإصلاح والإفساد، فيتعود الحذر، ويدقق في وزن حروفه، إذ هاهنا يظهر الورع، فليس غير النادر الشاذ من الناس يستعمل يده ورجله للبطش والأذى، لكنه اللسان اللسان الذي أشار إليه عمر بن الخطاب فقال: “لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل”(ابن المبارك، الزهد، ص234).
ولذلك قال يونس بن عبيد: “يعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم”. وباللسان الطاهر: سبق من سبق، وتقدم أبو بكر بدر بن المنذر المغازلي الزاهد صحبه بمراحل، فقال الإمام أحمد: “من مثل بدر؟. بدر قد ملك لسانه” (تاريخ بغداد، ج7، ص 104). ملكه وسيطر عليه، وتصرف فيه كيف شاء الورع لا كيف ينطلق الهوى. وسئل إبراهيم الخواص الزاهد عن الورع ما هو؟ فقال: ” أن لا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أو رضي”(المرجع السابق، ص104). فجعله كل الورع. لا يعني بذلك نفي صورة أخرى للورع، وإنما راعي حاجة السائل وطبيعة الظرف التي راعاها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”(صحيح البخارى).
المسارة في نصيحة القادة:
وهذا النور له بريق لامع يحرم الفتن من بيئتها الطبيعية التي تتوالد فيها، ولكن ربما ظن داعية أن المسارة في النصيحة تنافي طبائع الإسلام وسمته في الحث على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ورأى في إنكار المرأة على عمر رضي الله عنه في المسجد جهارًا دليلا ينفي نورانية المسارة.
والأمر ليس كذلك عند من عرف مقاصدنا، إذ لو افترضنا صحة قصة إنكار هذه المرأة على عمر التي يضعفها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفحصنا فحواها، لما وجدنا لها علاقة بسياسة أو عقيدة أو موقف عام جماعي، وإنما تتناول أمر مهور الزوجات، أو أمر توزيع بعض العطايا على من له حق في بيت المال، في قصة أخرى تروى، فضلا عن أن العامي المجهول الذي اعترض أو المرأة المجهولة، لا يصلح عملهما أن يناهض الأدب الذي اختاره سعد بن أبي وقاص أو أسامة، وهما على ما يعرف عنهما من الفقه والتجربة، ولا أن يكون مصدرًا لأصول الدعوة وابن حجر يفتيك بعد ابن حكيم بوجوب الإسرار عند خوف المفسدة.
إن نصيحة قادة العدل الذين يتحرون السير على موجب فقه الراشدين غير مواقف العلماء الجريئة في الإنكار على الظلمة والمبتدعة، وإنما ندعو نحن إلى مسارة لا في مثل هذه الأمور التي يحتاجها الناس في أمر معاشهم اليومي، بل فيما يتعلق بسياسة الجماعة الداخلية والخارجية ومواقفها العامة، وفي أيام الفتنة خاصة، خوفا من استغلال أصحاب الأغراض للنقد المعلن، أو اغترار المخلصين السذج وأصحاب التجربة القليلة بظاهره، إذ تصبح النصيحة في موطن يوجد فيه مثل هؤلاء مترددة بين مصلحتين: مصلحة علانية النقد، ومصلحة عدم إتاحة فرصة لاستغلال المغرض أو لاغترار الساذج به. وبين ضررين: ضرر الاقتصار على إسماع النصيحة لنفر قليل فقط، وضرر الاستغلال والاغترار، فيعمل بالقاعدة الفقهية العامة في دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وجلب أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وهي قاعدة أجمع الفقهاء على اعتبارها ويقرها العقل، وتوجبها التجارب الوافرة في تاريخ الإسلام القديم والحديث.
بل وإن عمر رضي الله عنه قد أسرع هو نفسه قبل غيره إلى الامتناع عن بحث الأمور العامة أمام الجمهور الواسع الذي قد يضم المغرضين والسذج، واقتصر على إسماع من يظن فيه الفقه والنبل فحسب، وذلك حين أراد أن يقوم في مكة أيام موسم الحج خطيبا ليفند لغطا لغط به بعض الجهال حول بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأحداث يوم السقيفة، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. “يا أمير المؤمنين: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على موضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة” فها قد تضافر لدليلنا من جديد: رأي ابن عوف، وفعل عمر، رضي الله عنهما.
وهكذا الداعية: لا يضع كلامه إلا عند من هو أهل لوعيه، وليعتبر بما رأينا في الفتن، فإنها تكون أول ما تكون خفيفة، ثم يتلقف أصحاب شهوة الرياسة نقد الثقات، ويزيدون فيه عشرة أمثاله، فيكون هدمًا. إن الداعية الفطن الكيس إن كان عنده قول يري أن لا بد من قوله لغير قادته فإنما يقوله لأهل الفقه من الدعاة وأشرافهم الذين تأدبوا بآداب السنة طويلا، ويسارر به، لا يوزعه هاهنا وهاهنا. يسارر، أو يتحرى الحلماء النبلاء العقلاء القدماء، أصحاب الأقدام المنظورة المأثورة.
تطبيقات عملية:
- ناقش كيف تؤدي هذه الأنوار الثلاثة إلي تماسك الصف….واجب للمربي
- قيم نفسك في هذه الأنوار…..واجب للأفراد
 موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org