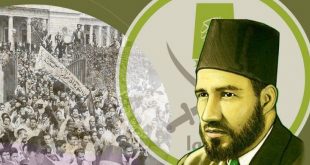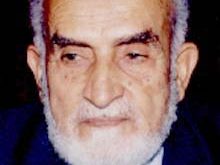الافتتاحية: الآية 36 من سورة الإسراء
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الأسراء:36)
يقول الإمام القرطبى رحمه الله: “﴿وَلا تَقْفُ﴾ أَيْ لَا تَتْبَعُ مَا لَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْنِيكَ. قَالَ قَتَادَةُ: لَا تَقُلْ رَأَيْتُ وَأَنْتَ لَمْ تَرَ، وَسَمِعْتَ وَأَنْتَ لَمْ تَسْمَعْ، وَعَلِمْتَ وَأَنْتَ لَمْ تَعْلَمْ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَذُمَّ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ شَهَادَةُ الزُّورِ. وقال القتبي: المعنى لا تتبع الحدس وَالظُّنُونَ، وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ. وَأَصْلُ الْقَفْوِ الْبُهْتُ وَالْقَذْفُ بِالْبَاطِل. وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَنْهَى عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْقَذْفِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ وَالرَّدِيئَة. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾ أَيْ يُسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا اكْتَسَبَ، فَالْفُؤَادُ يُسْأَلُ عَمَّا افْتَكَرَ فِيهِ وَاعْتَقَدَهُ، وَالسَّمْعُ والبصر عما رأى مِنْ ذَلِكَ وَسَمِعَ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْأَلُ الْإِنْسَانَ عَمَّا حَوَاهُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَفُؤَادُهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”(تفسير القرطبى، بتصرف).
يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: “وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة! فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده، أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبها، وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا. أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة، وكلما روى الإنسان رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين، وما لم تتثبت من صحته: من قول يقال ورواية تروى. من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل. ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». وفي سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل :زعموا» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تريا» وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه، والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته، وفي مشاعره وأحكامه، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية، ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها”(فى ظلال القرآن).
دروس مستفادة من الآيات:
- التثبت والتحقق والتيقن قبل نقل الأخبار، وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات منهج إسلامى أصيل.
- السمع والبصر والفؤاد وسائر الجوارح أمانة يجب أن يستعملها الإنسان فيما يرضى الله وسيحاسبه على ذلك يوم القيامة.
- …………………………..أذكر دروساً أخرى.
الإقلال من الكلام:
فإنما يسألك الله عن فصاحة قلبك لا فصاحة لسانك؛ فليس أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط، ولا أجمل من كلام الناصح الآمر بالمعروف إذا أصلح؛ فالمؤمن يحسبه الجاهل صميتاً عيياً، وحكمته أصمتته، ويحسبه الأحمق مهذاراً، والنصيحة لله أنطقته، وهذا هو عين الصلاح الذي أراده الصالحون لكل لسان، فمن صلح لسانه عندهم، أي نطق بالخير وسكت حين الفتن: صلح عمله كله، وفي ذلك كان التابعي يونس بن عبيد يقول: “خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما: أمر صلاته، ولسانه” ثم زاد فقال: “ما صلح لسان أحد إلا وصلح سائر عمله” فهو المفتاح المبارك، ولود الخيرات، من أصلحه تفتحت فيه البصائر، وهجر الكبائر والصغائر.
والكلمة الطيبة ترفع الدرجات؛ ولذلك جاء كثير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية اللسان، وجعل سكوته في موطن الشبهة ترجمة الإيمان، فقال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت” (رواه البخارى ومسلم). فقول الخير من الإيمان، حتى أن الكلمة الواحدة لترفع صاحبها درجات، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم: “إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات”)رواه البخارى). ومن أجل ذلك رغب في هذه الكلمات الخيرة، فقال: “أطيبوا الكلام” )صحيح الجامع الصغير (يدلهم على باب الدرجات، وسلم العلو، إذ ليس أروع من كلمة حق منك، أو إصلاح، حين يفتتن لسان غيرك؛فإن عجز المرء: فإنه السكوت، إذ ربما تبدل الكلمة الواحدة ميزانه فيردي، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم :”إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا، يهوي بها في جهنم”)رواه البخارى). والميزان في هذا، هنا في الأقوال كما في الأعمال، هو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:”إذا حاك في نفسك شيء فدعه”)صحيح الجامع الصغير(.فإن “أكثر خطايا ابن آدم في لسانه”)صحيح الجامع الصغير (فلينظر داعية نفسه، وليرفق بها، وليلزم الجمل المفيدة، وحروف البناء، وليطب كلامه، يكون طيبا، فإن نصف التربية قول موجه، وليدع حرفا حاك في الصدر، فإن الشيطان يؤز، يحرف النفس إلى طلب انتصار وغلبة، فتكون الوخزة، والتهمة المتسرعة، والنبزة.
والطريق الأقرب لهذا الرفق الطيب أن يتشبه الداعية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقلده لتشمله دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- حين دعا له فقال: “اللهم اهد قلبه وثبت لسانه”(طبقات ابن سعد). فلم يتقلب لسان علي؛ فانظر: لم يكتف حتى ذكر اللسان، وبين أن ثبات اللسان قرين هداية القلب أو نتاجها! وإلا، فإن لنا حين نرى لسانًا قلقا لاحنا أن نتهم القلب الذي تحته بعدم استكمال الهداية، وأنه بحاجة إلى الواعظ الناصح الذي يعلمه الفصاحة في الحق، ويدق له وتدا يثبته في تيارات الأهواء .وإنما هو نموذج دعاء حفظه الرواة فروه لك، تعليما للغة الدعاء وتلقينا، كي تقول لأخيك يوم ترى بوادر الفتن: “اللهم اهد قلبه وثبت لسانه” (طبقات ابن سعد). تقولها بعد قولك. اللهم اغفر لي، ولأخي هذا مرة بعد مرة، كلما لقيته.
وصواب القول من صواب العمل وبهذا تكون قد أديت واجبك، وأحسنت أجمل الإحسان الأخوي.أما فقه الدعوة، فمن واجبه أن يستمر في عرض غرر النصائح، لعل حريصا ينتفع، أو جريئا يتأنى، ليتأمل وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ يقول له: “أقلل من الكلام، فإنما لك ما وعي عنك”(عيون الأخبار). أو وصية عمر الفاروق رضي الله عنه إذ يترحم فيقول: “رحم الله امرأً أمسك فضل القول، وقدم فضل العمل” (عيون الأخبار).أو وصية أبي الدرداء رضي الله عه لما ذهب في الصراحة لأبعد منهما فقال: “أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد، لتسمع أكثر مما تقول(عيون الأخبار).
تلك وصاياهم؛ فقد كانوا جيل جهاد وبناء، ربته المعاناة والممارسة، وصقلته الشدائد، وعرفوا من خلالها قدرة البذل الصامت على تناوش الغايات. وأن اللغو شين كله، وضرره أيام التمكين ليس أقل من ضرره أيام المحن. وعلى دعاة الإسلام أن ينطلقوا اليوم من هذه الحقيقة، فينطقوا فيما بينهم بالخير الواسع، والمعني الكبير، والفقه المفيد، في عبارة ضيقة المبنى موجزة، فإن الإكثار مظنة الخطأ، من غيبة، أو تهمة برئ، أو اضطرار لاستعمال دليل ضعيف، ومن وجد في نفسه بقية شوق إلى تحريك اللسان فدونه القرآن، ومزيد التسبيح، والحمد. ودونه مجالس الواهمين والدنيويين، يصدع فيها بحق الإسلام ما شاء. وهذا النمط التربوي لابد منه لجيلنا، كي تتهيأ الجوارح لفضل فائض من العمل بمثله أمات عمر الفتن في جيله، فأتته الفتوح. وفتحنا المنتظر رهن بطريقة عمر.
وقد ذهب الصمت عرفا؛ فكان نتاج ذاك الحرص الراشد على الصمت الفعال فوجا آخر من التابعين يترادفون على درب العمل ويجددون النصح التربوي بإقلال الكلام.منهم التابعي المهلب بن أبي صفرة الأزدي حين يقول: “يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم زائدًا على لسانه”(تاريخ بغداد). كلمة تستوى في ظاهرها مع ما نسمع من طرف لسان أكثر الوعاظ، لكنها عند من يعرف المهلب قائدًا متحمسا لقتال الخوارج تمثل حساسية روح وخزها شذوذ الخوارج عن إجماع المسلمين، ولذعة قلب كواه تفاصحهم وتبجحهم الزائد إزاء عقل يناديهم باجتماع تتمكن معه جيوش الإسلام من مواصلة الزحف على معاقل الكفر بدل تطاحن داخلي بين طرفين كلاهما موحد. ثم عمر بن عبد العزيز الذي يقول: “من عد كلامه من عمله قل كلامه”(ابن المبارك، الزهد). يذكرك، لعلك نسيت، أنك تحاسب على الكلام حسابا مثل الذي على عمل الجوارح. وانظر الترابط بين مشاهدته الواضحة لهذه الحقيقة، وبين رشده وعدله وطبيعة حكمه الفذة. حتى إن المطالع لكتب المواعظ ليكاد يرى تواطؤا بينه وبين أساتذة التربية الذين عضدوه على إقرار الإقلال من الكلام خطة تربوية للمجتمع، ومن أبرز هؤلاء: الحسن البصري، وميمون بن مهران، وعبيد بن عبد الله بن عتبة، وبقية فقهاء المدينة.
ونقلة قريبة إلى الجيل الذي بعدهم ترينا استمرار هذا السمت عند الثقات، ففي مرثية المحدث الثقة محمد بن كناسة الكوفي لخاله الزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم إشادة بهذا الخلق وبيان تكامله مع الصفات الإيمانية الأخرى وارتباطه بها، فيقول:
زهود يري الدنيا صغيرا عظيمها و تراه لحق الله فيها معظما
وأكثر ما تلقاه في القوم صامتا فإن قال بذ القائلين وأحكما
فاستصغار الدنيا، والوفاء، لا يبدو جمالهما الكامل إلا إذا اقترنا بصمت. ثم أستاذ الزهد في الجيل التالي: بشر بن الحارث الحافي، عضيد أحمد بن حنبل.قالوا: “ما أخرجت بغداد أتم عقلا، ولا أحفظ للسانه من بشر”(تهذيب التهذيب) فأبانوا من وجه آخر ارتباط حفظ اللسان بالعقل، فهو قد حفظ لسانه من اللغو، فوهبه الله لسانا جريئا في موقف صدق إزاء أمير خدعته البدعة، فكان يجوب شوارع بغداد يوم تعذيب الإمام أحمد ينتصر له، ويثبت الناس ويقود جمهور محبيه المتكتل أمام قصر المعتصم. وهذا اللسان –لعمرو الله- هو اللسان الذي يجب أن يحرص عليه الدعاة، وبه يفخرون. لسان اللهج بحديث في مسند أحمد، والترويج لعقيدة أحمد، وقيادة من يقتفي طريقة أحمد وطرق من سبق أحمد ومن خلفه من أئمة الفقه والفضل، لا لسان التثبيط والتخذيل. ورحم الله داعية أمسك فضل القول، وقدم فضل العمل.كلمة قالها عمر، ولم نبتدعها نحن.
وتظل مسوغات الصمت الأخرى من بعد هذا تستجلب لها خيارًا آخرين، كما استجلبت المهلب وبشرًا الحافي، فيقول التابعي الكبير عطاء ابن أبي رباح: “إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا ثلاثًا: كتاب الله أن يتلوه، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، وأن ينطق بحاجته التى لابد منها” ويضرب الحسن البصري -إذ يختار لنفسه الصمت-مثلا للمفكر والمهذار يقول فيه: “كانوا يقولون: إن لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول: يرجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى القلب، فما أتى على لسانه تكلم به”(ابن المبارك، الزهد). ويتولى علم السير تعريفنا بحكيم من هؤلاء الذين عناهم الحسن، يعرض كلامه على قلبه، فلا ينطق قبل أن يعد لنفسه جوابًا. اسمه: حاتم الأصم، زاهد قديم رأوه قليل الكلام، فسألوه، فقال: “إني لا أحب أن أتكلم كلمة قبل أن أعد جوابها لله، فإذا قال الله تعالى لي يوم القيامة: لم قلت كذا؟ قلت: يارب: لكذا”(تاريخ بغداد) وعد الفضيل بن عياض كثرة الكلام خصلة من ثلاث خصال تقسي القلب، وزاد فجعله مرة أخرى علامة من علامات النفاق إذا اقترن بقلة العمل، فقال: “المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل” فطلب من حملة القرآن، من أجل ذلك، أن يقفلوا أفواههم إلا من حديث خير، فإن حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، وليس أوعظ من أن يتصور أحدنا نفسه مع أولئك اللاغين المازحين من طلبة الحديث المخالفين لأعراف شيوخهم، والفضيل يشتاط غضبا وينادي: “مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا يا ورثة الأنبياء، إنكم أئمة يقتدى بكم” وإنها لحقيقة يذكرنا بها الفضيل يجب أن لا تغيب عن بالنا. إن مجرد حملنا للقرآن، وطلبنا للحديث يضعنا في مقام القدوة والإمامة، ولابد من وفاء حق هذا المقام.
ترك النجوى وصون الأذن عن استماع الغمز:
فيدعها في عافية من بعد ما عافى لسانه من تتبع زلات الناس وانتبه لعيوب نفسه، إذ: ليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب، وأقرب وقوعًا في الفتنة:
فسمعك صن عن قبيح الكلام كصون اللسان عن النطق به
فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه
وهذا ما يستدعيه التعجل الإيماني المستحب للسائر في طريق الأنوار، فإن استماعه للهماز يضيع عليه وقته الثمين إن لم يضره، ويفوت عليه الالتذاذ بترك النجوي؛ فإن مجالس المؤمنين لم تعرف إلا زيادة الإيمان لها هدفا، وكان ابن رواحة يأخذ بيد أبي الدرداء، رضي الله عنهما، ويقول: “تعال نؤمن ساعة”(ابن المبارك، الزهد)، فيتذاكران أمر الإيمان، ويتعرفان على مسالك التوبة، ويتآمران بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر أبا بكر بن عمرو بن حزم، رحمهما الله، بالجلوس للتعليم، ويقول له: “ولتجلسوا، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا”( صحيح البخارى) وجعل أحمد بن أبي الحواري الدمشقي المجالسة دواء قسوة القلب، فقال:”إذا رأيت من قلبك قسوة فجالس الذاكرين، وأصحب الزاهدين”.
فمجالس المؤمن عزيزة، ولا ينبغي أن يجلس إلا بنية أن يؤمن ساعة ثم يقوم، متداولا أية أو حديثا أو وصية حكيم من صالح المؤمنين، وليس من حقه أن يميل بالجالسين معه إلى نقد اجتهادات قادته بما يهاب أن يذكره لهم صريحا. وكذلك غدوات المؤمنين وروحاتهم، فإنها ثمينة مثل مجالسهم، ومن لم يجد عند الذين حوله فقها فإن عليه أن يسيح طلبا له، كما كان التابعي علقمة بن قيس النخعي الكوفي قول لأصحابه: “امشوا بنا نزدد إيمانًا، يعني يتفقهون”. أو يذهب إلى من يرجو أن يلين له قلبه إذا ألهاه الصفق بالأسواق وأحاديث الرواتب وفرق الأسعار، كما كان التابعين ميمون بن مهران يذهب إلى سيد التابعين الحسن البصري ويطرق بابه ويقول له: “يا أبا سعيد: قد آنست من قلبي غلاظة: فاستلن لي منه”. فإن لم يجد الصاحب الجليس الصالح، والمداوي الملين، فإن أمامه خلوة ساعة تذيقه حقيقة اللذة، فإنه “ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل” كما يقول التابعي مسلم بن يسار. ثم أمامه المحراب، يذكره به التابعي بكر بن عبد الله المزني ويتساءل :”من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان”.
والاجتهاد لا ينمو في الجيوب؛ فأما منصف نفسه فيطلب ذلك، من مجلس أو رحلة أو خلوة لبث بمحراب، يأنس بمخالطة من شاء من أفراد جماعة الإيمان، أو يقتدي بما يروي له من فعل المهتدين، وأما المشرف على ضلالة، فإنه يتوارى مع صحب له عن العيون، ويكتم سره عن الجماعة، ويبثه لمن يهواه، فيؤز بعضهم الحمية النفسية في البعض الآخر، فيكون حنق، فتثبيط، فتسويغ لا يبرأ من تدليس، فإذا هو افتتان. تلك التي عرفها عمر بن عبد العزيز فقال: “ما انتجي قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة”(أحمد بن حنبل، الزهد). وهذه هي بداية كل بدعة في تاريخ المسلمين، تبدأ بالنجوى، ثم يكون الاستدراج؛ فالنجوى دون الجماعة في المفاهيم التي هي من الدين، أو في خلع الطاعة الشرعية التي هي من الدين أيضًا، والتي بسببها سمى الخوارج الخالعون للطاعة: مبتدعة، يقرن ذكرهم بالجهمية والمرجئة، كل ذلك ضلالة داخلة في قول عمر. ولا تغير النية الصالحة في طبيعة النجوى أو تسحب عليها ذيل الصلاح تبعًا، ولا ادعاء الاجتهاد وطلبه من خلالها، فإن الاجتهاد لا يترعرع سرًا، لاحتياجه دوما إلى التقويم، وإلى الشهادة له أو عليه من قبل الآخرين، وليس بتاح ذلك في أجواء التناجي المتوارى المستخفي الذي يشبه التهامس. ولقد أظهرت لنا التجارب الكثيرة أن معظم التناجي يؤدي إلى الخروج ونكث البيعة، ولا تتجاوز أن تكون مرحلة أولية للماشي في درب الفتنة، دري أو لم يدر، ولا تتجاوز حجة المتناجي أن تكون هي نفسها حجة الخارج، كلاهما يدعي أنه يريد مصلحة الإسلام، وأنه يمارس ضربا من العبادة، والخطأ يلفهما لفا.
كل الخوارج مخطئ في مقالته وإن تعبد فيما قال واجتهدًا.
وتقريرات سيد قطب رحمه الله لمجالات النجوى المذمومة في القرآن الكريم تلتقي مع هذا الذي نقول: ويذهب لأبعد ممن يتوهم أن الله تعالى قد ذم النجوى في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقط. فهو يعقب على الآية الكريمة ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فيقول: “لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى، وهي أن تجتمع طائفة بعيدًا عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة، لتبيت أمرًا. وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه، فيعرضه على النبي -صلى الله عليه وسلم- مسارة إن كان أمرًا شخصيًا لا يريد أن يشيع عنه في الناس: أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة، التي ليست من خصوصيات هذا الشخص. والحكمة في هذه الخطة، هو ألا تتكون جيوب في الجماعة المسلمة، وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراتها ومشكلاتها، أو بأفكارها واتجاهاتها، وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسلمة أمرًا بليل، وتواجه به الجماعة أمرًا مقررًا من قبل، وتستخفي به عن أعينها، وإن كانت لا تختفي به عن الله، وهو معهم ﴿إذ بيبيتون ما لا يرضى من القول﴾.و هذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها.ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة، تتلاقى فيه وتتجمع للصلاة لشؤون الحياة، وكان المجتمع المسلم كله مجتمعا مفتوحًا، تعرض مشكلاته التي ليست بأسرار للقيادة في المعارك وغيرها، والتي ليست بمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن عرضا عامًا. وكان هذا المجتمع المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا طلق الهواء، لا يتجنبه ليبيت من وراء ظهره إلا الذين يتآمرون عليه، أو على مبدأ من مبادئه –من المنافقين غالبا- وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع.وهذه حقيقة تنفعنا. فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئا من هذه الظاهرة، وأن يرجع أفراده إليه وإلى قيادتهم العامة بما يخطر لهم من الخواطر، أو بما يعرض لهم من خطط واتجاهات أو مشكلات”(في ظلال القرآن).
تطبيقات عملية:
- للدارس قيم نفسك في إطار ماتعلمته من هذه الأنوار
- للمربي ناقش مع إخوانك كيف يساعد بعضهم بعضا في التحلي بهذه الأنوار
 موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org