الافتتاحية: الآيتان133-134من سورة آل عمران
قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران، 133-134).
في هذه الآيات الكريمات يدعونا الحق سبحانه إلى التنافس والمسابقة والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه وجنته العظيمة التى أعدها لعباده المتقين الذين تحرروا من عبودية المال فأنفقوه في سبيل الله في كل أحوالهم من العسر واليسر والشدة والرخاء على السواء، وتحرروا من هوى النفس وتخلصوا من سورة الغضب؛ فملكوا أنفسهم وكظموا غيظهم وعفوا عمن ظلمهم وأحسنوا إلى الناس محسنهم ومسيئهم، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾، “لَا يَعْمَلُونَ غَضَبَهُمْ فِي النَّاسِ بَلْ يَكُفُّونَ عَنْهُمْ شَرَّهُمْ وَيَحْتَسِبُونَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى، ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أَيْ مَعَ كَفِّ الشَّرِّ يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَبْقَى فِي أَنْفُسِهِمْ مَوْجِدَةً عَلَى أَحَدٍ، وَهَذَا أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ وَلِهَذَا قَالَ، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فَهَذَا مِنْ مَقَامَاتِ الْإِحْسَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ، «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، مَا نَقَصَ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ الله عبداً بعفو إلا عزاً، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ». وَرَوَى الْحَاكِمُ في مستدركه، عَنْ أُبّي بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال، «ومن سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ الْبُنْيَانُ وَتُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، ويعطِ مَنْ حَرَمَهُ، ويصلْ من قطعه»”( تفسير القرآن العظيم، بتصرف).
والصفات الخلقية التى وصف الله تعالى بها المتقين في الآيات وجعلها سبيلاً إلى مغفرته ورضوانه وجنته في الآخرة هى نفسها الصفات الخلقية التى عدها الشهيد سيد قطب من عوامل النصر في الدنيا أيضاً، وذلك عند تفسيره لهذه الآيات في إطار المحاور الكلية للسورة؛ فهو يربط ربطاً وثيقاً بين النصر في المعركة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبين النصر في المعركة الأخلاقية. يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله، “فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية، والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «أحد» إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب. والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب، والالتجاء إلى الله، والالتصاق بركنه الركين. والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله، والرجوع إلى كنفه من عدة النصر، وليست بمعزل عن الميدان! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر، والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي. وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر، فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة، والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك. ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ما لم يقم هذا كله على أساس المنهج الرباني، في الانتصار على النفس، والغلبة على الهوى، والفوز على الشهوة. وتقرير الحق الذي أراده الله في حياة الناس. ليكون كل نصر نصراً لله ولمنهج الله. وليكون كل جهد في سبيل الله ومنهج الله. إنه منهج الله وحده. ولا حق في هذا الكون غيره. وانتصاره لا يتم حتى يتم أولاً في ميدان النفس البشرية. وفي نظام الحياة الواقعية. وحين تخلص النفس من حظ ذاتها في ذاتها، ومن مطامعها وشهواتها، ومن أدرانها وأحقادها، ومن قيودها وأصفادها. وحين تفر إلى الله متحررة من هذه الأثقال، وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها، لتكل الأمر كله إلى الله، بعد الوفاء بواجبها من الجهد والحركة. وحين تحكم منهج الله في الأمر كله، وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصاراً في ميزان الله. وإلا فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية، الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة. والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها، وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق. ومن ثم هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب، والسيطرة على الأهواء والشهوات، وإشاعة الود والسماحة في الجماعة.. فكلها قريب من قريب والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية.. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ﴾ سارعوا فهي هناك، المغفرة والجنة﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾” (فى ظلال القرآن، بتصرف).
دروس مستفادة من الآيات الكريمة،
- صفات المتقين الواردة في الآيات من عدة النصر في الدنيا، ومن أسباب دخول الجنة يوم القيامة.
- كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم من أخلاق المؤمنين اللازمة في معركة القيم والهوية.
- …………………………………………………….أذكر دروساً أخرى.
سعة الصدر
سعة الصدر من الأخلاق التى لا غنى عنها لكل من ارتاد ميدان الدعوة، أو تقدم الصفوف فى ميدان الثورة، أو تصدر فى ميدان الإصلاح “والعرب تطلق سعة الصدر على الحلم والقوة، فهو كناية عن السرور وانبساط النفس وراحة البال وسعة الأفق”(التفسير المنير للزحيلى) وكل ذلك لازم للدعاة والثوار والمصلحين. ويرى الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله أن سعة الصدر ضرب من ضروب الصبر، و لا شك أن الصبر لازم لهؤلاء أيضاً فيقول: “الصبر ضربان: بدني فعلاً؛ كتعاطي الأعمال الشاقة، أو انفعالاً كالثبات على الآلام، ونفساني: وهو منع النفس عن مقتضيات الطبع، فإن كان حبساً عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان في حال الغنى سمي ضبط النفس، ويضاده حالة البطر. وإن كان في حال مبارزة الأقران سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في كظم الغيظ والغضب يسمى حلماً ويضاده النزق، وإن كان في نائبة من النوائب سمي سعة الصدر ويضاده الضجر وضيق الصدر”(تفسير النيسابورى). أما الشوكاني فيرى أن سعة الصدر جزء من الحلم الذى يجمع بين سعة الصدر وطيب النفس، وهما لازمان للدعاة والثوار والمصلحين. يقول رحمه الله: “الحلم سعة الصدر وطيب النفس فإذا اتسع الصدر وانشرح بالنور أبصرت النفس رشدها من غيها وعواقب الخير والشر فطابت وإنما تطيب النفس بسعة الصدر وإنما يَتَّسِع الصَّدْر بولوج النُّور الْوَارِد من عِنْد الله وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿أَفَمَن شرح الله صَدره لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ على نور من ربه﴾”( الشوكاني، فيض القدير).
وقد سمى الإمام ابن القيم رحمه الله سعة الصدر ميدان الرحمن الذى مهده لأنبيائه وأوليائه وجعله خلقاً لازماً لهم جميعاً. يقول رحمه الله: “فَمَيْدَانُ الرَّحْمَنِ الَّذِي بَسَطَهُ هُوَ الَّذِي نَصَبَهُ لِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِهِ، وَمَعَ الْغَرِيبِ وَالْقَرِيبِ، وَهِيَ سِعَةُ الصَّدْرِ، وَدَوَامُ الْبِشْرِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ، وَالْوُقُوفُ مَعَ مَنِ اسْتَوْقَفَهُ، وَالْمِزَاحُ بِالْحَقِّ مَعَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ أَحْيَانًا، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَلِينُ الْجَانِبِ حَتَّى يَظُنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ أَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ، وَهَذَا الْمَيْدَانُ لَا تَجِدُ فِيهِ إِلَّا وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ مُبَاحًا يُعِينُ عَلَيْهِمَا”(ابن القيم، مدارج السالكين) وهذا الميدان هو ميدان الدعاة والثوار والمصلحين؛ إذ إن رسالة هؤلاء جميعاً موجهة إلى عموم الناس ولا يصلحهم ويؤلف قلوبهم مثل حسن الخلق وفى مقدمته سعة الصدر وبسط الوجه والحلم وما كان من هذا القبيل. “وسائس الناس ومدبر أمورهم يحتاج إلى سعة الصدر واستشعار الصبر واحتمال سوء أدب العامّة”(عيون الأخبار) وقد كانت سعة الصدر من وصية عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعري رضى الله عنهما “فقد كتب عمر إلى أبي موسى، إياك والضجر، والغضب والقلق والتأذي بالناس عند الخصومة”(الصلابي، عمر بن الخطاب).
وسعة الصدر من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام “إذا غضب لم يظهر عليه من أثر الغضب إلا نفرة عرق بين حاجبيه؛ ذلك أنه كان ميّالا للجدّ يكظم غيظه ولا يريد أن يظهر غضبه، لما جبل عليه من سعة الصدر وصدق الهمة والوفاء للناس، ومن البر والجود وكرم العشرة، وما كان عليه إلى جانب ذلك من ثبات العزيمة وقوة الإرادة وشدة البأس ومضاء التصميم مضاء لا يعرف التردد. وهذه الصفات مجتمعة فيه كانت ذات أثر عميق في كل من اتصل به، فمن رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبّه”(محمد حسين هيكل، حياة محمد). والدعاة والمصلحون والثوار فى حاجة ماسة لاقتفاء أثر الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه فى معاملة الناس وتأليف القلوب.
وقد تشرب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم واقتدى به فى ذلك التابعون وتابعوهم بإحسان: فقد “شتم رجلٌ الشعْبي فقال له، إن كنتَ صادقاً فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وشتم رجلٌ أبا ذر الغفاري فقال له أبو ذر، يا هذا لا تغرق في شتمنا، ودعْ للصلح موضعاً، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، وقيل لقيس بن عاصم، ما الحلم؟ قال، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.. وقالوا، ما قُرن شيء أزين من حِلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة!! وقال الحسن، المؤمن حليم لا يجهل وإن جُهل عليه. وتلا قوله تعالى، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ وقال عليّ، من لانت كلمته وجبت محبته، وحِلْمك على السفيه يُكثر أنصارك عليه. وأسمع رجلٌ عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره، فقال، لا عليك، إنما أردتَ أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً، انصرف إذا شئت”(محمد الغزالى، جدد حياتك).
وسعة الصدر من عوامل النجاح فى مهام الدعوة والإصلاح والعمل الثوري. يقول الشيخ محمد الغزالى رحمه الله: “الحلم والأناة والتجاوز من ألزم الخلال للداعية. ربما فشل القول اللين فى إقناع فرعون بأنه بشر عادى وليس إلها كما يزعم، بيد أن هذا الفشل لا يقيم سياسة الدعوة على المخاشنة وإغلاظ القول، بل يجب أن تبقى هذه السياسة ملتزمة السماحة والترفع. وللكفاح بين الحق والباطل أجل محدد استأثر الله بعلمه، وقد ظهر من سنن الله فى الأمم السابقة أن القدر الأعلى يتدخل على نحو ما، فيحق الحق ويبطل الباطل، طال الزمان أو قصر. وعلى المؤمنين أن يبقوا حتى اللحظات الأخيرة متمسكين بفضائلهم وشرف أنفسهم، يؤثرون الإقناع على التحدى، والتعليم على العدوان”(محمد الغزالى، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج). “والجاهلية التى عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محوها كانت تقوم على ضربين من الجهالة، جهالة ضد العلم وأخرى ضد الحلم، فأما الأولى فتقطيع ظلامها يتم بأنواع المعرفة وفنون الإرشاد، وأما الأخرى فكف ظلمها يعتمد على كبح الهوى ومنع الفساد، وقد كان العرب الأولون يفخرون بأنهم يلقون الجهل بجهل أشد . ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا؛ فجاء الإسلام يكفكف من هذا النزوان، ويقيم أركان المجتمع على الفضل فإن تعذر فالعدل، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا هيمن العقل الراشد على غريزة الغضب. وكثير من النصائح التى أسداها الرسول للعرب كانت تتجه إلى هذا الهدف” (محمد الغزالى، خلق المسلم(.
ويؤكد الشهيد سيد قطب رحمه الله أن الخير أصيل فى النفس الإنسانية وأن الشر فيها طارئ، ويوصى الدعاة والمصلحين والمجاهدين أن تتسع صدورهم لأخطاء الناس وضعفهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعماقهم والتأثير فيهم وعند ذلك ستبهرهم النتائج فيقول: “عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس، نجد أن هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العين من أول وهلة. لقد جربت ذلك مع الكثير، حتى الذين يبدو في أول الأمر أنهم شريرون أو فقراء الشعور. شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية -غير المتصنعة- باهتمامهم وهمومهم ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم، حين يمنحوك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص، إن الشر ليس عميقا في النفس الإنسانية إلى الحد الذي تتصوره أحيانا. إنه في تلك القشرة الصلبة من الثمرة الحلوة للحياة التى تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن في جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم، وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كذلك. وشيء من سعة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع المثيرون، لقد جربت ذلك، جربته بنفسى فلست أطلقها مجرد كلمات مجنحة وليدة أحلام وأوهام”(سيد قطب،).
“والدعاة إلى الله اليوم بحاجة إلى وقفة طويلة مع إسلام خالد، وإسلام عمرو فأعماق الحادثتين أكبر من الحدث الآني، وهو دعوة ملحة لهؤلاء الدعاة أن يتعاملوا مع نفوس الناس. وأخص بالذكر الخصوم وقيادات الخصوم، ليحولوا تلك النفوس إلى الإسلام .وليكن أعظم أهدافهم هو جعل طاقات وعبقريات هؤلاء الخصوم تنصب في معين الإسلام وتذود عنه. تماما كما قال عليه الصلاة والسلام (ولو كان جعل جده ونكايته مع المسلمين). وليكن لدى الدعاة من سعة الصدر أن يقولوا لخصومهم ما قاله عليه الصلاة والسلام لأكبر أعداء الإسلام ذات يوم لخالد بن الوليد (ولقدمناه على غير (“(منير محمد الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية).
ولا يختلف أحد على أن سعة الصدر لا تعنى أبداً إهدار الحقوق، أو التنازل عن الكرامة، أو التعايش مع الفساد، أو ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أو الركون إلى الظالمين، أو التخاذل عن رفض الظلم ومقاومته، وإنما يعنى التسامح والصبر والعفو العام عن العامة الذين أخطأوا فى حق الدعاة والمصلحين والثوار أخطاءً يسيرة من قبيل الشماتة بما حدث لهم، أو تحميلهم المسئولية على أفعال لم يقترفوا منها شيئاً، أو تصديق التهم الملفقة لهم، أو إ ظهار العداوة لهم اتقاءً لشر الانقلابيين أو طلباً لودهم، أو غير ذلك من المسالك المذمومة التى تركت آثاراً سلبية فى نفوس الدعاة والمصلحين والثوار تجاه هذا الصنف من الناس. وهذا الخلق هو الكفيل بتوفيق الله تعالى بتقريب الشقة، وتأليف القلوب، وتصحيح المفاهيم، وتوضيح الحقائق، وكسب أنصار جدد للثورة وللمشروع الإسلامى. أنصار ربما يدفعهم الإحساس بالندم على أخطائهم فى حق الدعاة والمصلحين والثوار إلى تقديم أقصى ما عندهم من دعم ومشاركة.
الإيثار:
لا يستغنى الدعاة والمصلحون والثوار عن خلق الإيثار، لأن طريق الدعوة والإصلاح والثورة ليست ممهدة مفروشة بالورود؛ ولكنها طريق صعبة طويلة، كثيرة العقبات، مليئة بالأشواك والمزالق والمنعطفات، ولذلك وجب على كل من يرتاد هذه الطريق أن يوطن نفسه على قبول السائرين معه فى نفس الطريق والتعاون معهم وإيثارهم على نفسه، فقد يتطلب الأمر أن يضحى بنفسه ليفتدى بعضهم فى موقف من المواقف “ولقد دعم الإسلام هذه المعاني النظرية والمراسيم العملية ببث أفضل المشاعر الإنسانية في النفوس من حب الخير للناس جميعا والترغيب في الإيثار ولو مع الحاجة ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر:9)”(حسن البنا، مجموعة الرسائل).
وقد عرف شيخ الإسلام إسماعيل الهروي الإيثار بقوله: “أن تعيش مع الخلق بغير نفس”( منازل السائرين) “والمعنى المستفاد من هذا القول أن تجعل رغائب نفسك ومطالب دنياك متأخرة عن مطالب الناس ورغائبهم، فلا تتقدم عند الطمع ولا تتأخر عند الفزع، ولا تطلب النصفة حين يحسن العفو، ولا تهن في ابتغاء الحق، ولا تضعف عندما يضيع قدره وميزانه في الناس، ولا تنابذ الجاهل مهما أصابك من جهله، فآخرتك أولى لك عند الله وآثر، وبالجملة يجمع هذه المعاملة مع الناس معنى الإيثار، ويفصله ويشرحه قول الحق تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في سورة الأعراف،﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾والآية تفصل لنا دستور هذا السلوك مع الناس بصورة جامعة مشرقة، تقربك من تذوق معنى الإيثار عملياً عندما يأمرك الله أن تأخذ العفو عمن ظلمك وأنت تقدر على النصفة، ثم يأمرك بأن تكون غايتك من الحياة فقط الدعوة إليه وإلى توحيده، وهو رب الخلق الذي يعلم أنك بهذا الجهاد ستُحْرم من دنياك، وسينالك أصحاب الطمع والظلم بالنكال والإيذاء، ولكنه جل شأنه لا ينسى كذلك وهو الحكيم العليم أنك شمعة تضيء، ونور يهدي، لما نزلت هذه الآية ، قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل، ثم سأل فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وقال جعفر بن محمد، ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وإذا قلنا إن هذه الآية هي دستورنا لرسالة المؤمن حيال الناس فلأنها وضحت حال صاحب الدعوة بين الناس في جوانب حياته كلها. ماذا يأخذ منهم، وماذا يعطيهم، وكيف يعاملهم. ما واجبه فيما يبذلونه من طاعة، فهو يأخذ منهم ما سهل عليهم تقديمه وما قدمته أنفسهم عن سماحة واختيار، ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم، وكل ذلك بأن يأخذ العفو من أخلاقهم كما يأخذ العفو من أموالهم، ويفيده في هذا المقام أن يعلم أن الخلق محبوسون في طاقاتهم فيما يقدمون من خير لأنفسهم وللناس، وأنهم موقوفون على قدرِ الله فيهم. وفي هذا يقول رسول الله للمؤمنين عامة: ” سددوا وقاربوا وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم” (صلاح شادى، تأملات فى كتاب مدارج السالكين، بتصرف).
والتربية على الإيثار لها مكانة كبيرة فى التربية الإخوانية، ففي تعريفه للإخوة يقول الإمام البنا رحمه الله: “وأريد بالأخوة أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة، والعقيدة أوثق الروابط وأعلاها، والأخوة أخت الإيمان والتفرق أخو الكفر، وأول القوة قوة الوحدة، ولا وحدة بغير حب، وأقل الحب سلامة الصدر، وأعلاه مرتبة الإيثار”(حسن البنا، مجموعة الرسائل)، وقد اهتم رحمه الله بتربية الإخوان عملياً على الإيثار، ومن أمثلة ذلك عندما “أعلن الإمام عن رحلة إلى الإسماعيلية، فجاء الإخوان المشتركون في الموعد المحدد، وجاء الأتوبيس، وكان عدد الإخوان أكثرَ من عدد المقاعد، فلما أذن الأستاذ المرشد بصعود الأتوبيس، إذا بمجموعة من الشباب تسارع وتزاحم ليحجز كل واحد مقعدًا يجلس عليه، فلما رأى الأستاذ هذا المشهد ألغى الرحلة، وكان درسًا عمليًّا في مراعاة النظام، والتدريب على الإيثار” وهذا ما يؤكده الدكتور على عبد الحليم أن التربية العملية على الإيثار كانت حاضرة فى كل المحاضن التربوية للإخوان ومنها الرحلة التى تهدف إلى تقوية “الحب والإيثار، وذلك بتقوية رغبة كل واحد من المشاركين فى الرحلة فى أن يبذل الجهد، ويقوم بالعبء الذى يريح به أحد إخوانه، وألا يستأثر براحة أو طعام أو شراب دون غيره من أعضاء الرحلة، فعند تبادل هذه المشاعر بين جميع الأعضاء يزداد الحب فى الله بين الإخوة ويحدث التدرب على الإيثار”( على عبد الحليم، وسائل التربية عند الإخوان). ولقد أثمرت هذه التربية ثماراً يانعة فى بستان الدعوة فى كل الظروف التى مرت بها “فلقد عاش الإخوان المسلمون الأخوة منهجاً وسلوكاً، نظرية وتطبيقاً؛ فتحقق في صفهم الحد الأدنى منها وهو سلامة الصدر، وضربوا أروع الأمثلة كذلك في الإيثار”(أشرف طبل، اسمع منا ولا تسمع عنا).
وقد أكد مرشدو الإخوان هذا المنهج التربوي باستمرار. يقول الأستاذ التلمسانى رحمه الله: “ما التحق مسلم بجماعة الإخوان المسلمين إلا وأمام عينيه هذا المعنى الضخم معنى العطاء لا الأخذ معنى الإفادة لا الاستفادة، معنى الإيثار لا الشح، معنى التضحية لا الأثرة ويا ليت كل من ينتمي إلى هيئة أو جماعة يفهم هذا المعنى حق الفهم، إذاً لتفادي المسلمون الكثير مما هم عليه، ولن يرفع عنهم إلا إذا عادوا إلى هذا الفهم السليم المستقيم”(عمر التلمساني، بعض ما علمني الإخوان) ويقول الأستاذ مصطفى مشهور رحمه الله: “ونريد من الأخ المسلم القدوة علي طريق الدعوة أن يقدر أهمية أخوته وحبه لإخوانه وأنها من ألزم عوامل النصر وأنها من دعائم الإيمان ” لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه” . وأعلي مراتب الأخوة في الله الإيثار وأدناها سلامة الصدر” ويوصى الأستاذ محمد مهدى عاكف الإخوان بقوله: “وحقِّقوا الأخوَّة بينكم وطبِّقوها عمليًّا، بدءًا من سلامة الصدر وحتى الإيثار فنحن نريد الأخوَّة الحقيقية التي تعين على الطاعة والقرب من الله، وتثري العمل وتدفعه للأمام.”(محمد مهدى عاكف، رسالة الربانية زادنا وسبيلنا). وجاء فى إحدى رسائل الدكتور محمد بديع إلى إخوانه قوله: “ومع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ظهر منهم أعظم الإيثار الذي قابله أعظم التعفف من المهاجرين؛ حيث عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يختار أحسن داريْه وجنتيْه وزوجتيْه، فتعفف قائلاً، جزاك الله خيرًا، بارك الله لك في مالك وأهلك ودارك، دُلَّني على السوق، وذهب يتاجر في الألبان حتى غنم مالاً كثيرًا، وصار المهاجري يطعم الأنصاري، والأنصاري يؤثر المهاجري”(محمد بديع، التخطيط للهجرة).
أما الوسائل العملية التى تعين الفرد على التخلق بخلق الإيثار فهى كثيرة ذكر الأستاذ صلاح شادى جملة منها فى قوله: “يظل واجب الداعية قائماً يلزمه بضرورة التبليغ والإسماع لكل هذه الطوائف والصبر عليها، حتى يصل إلى قلوبها ما وصل إلى سمعها من بلاغ، وهذا الفهم البسيط يدعوك لأن تكون لك ثلاثة مواقف، موقف من نفسك، وموقف من الأذى الواقع عليك، وموقف مع من أوقع بك الأذى. أما موقفك من نفسك، فأول ما تراها فيه مشهد الجهاد ومن المعلوم أن الله قد اشترى منك مالك ونفسك وعرضك بأعظم الثمن، فحق عليك إذن أن تقدم السلعة، ثانياً، مشهد الإحسان، أي مقابلة الإساءة بالإحسان، ويُهوِّن عليك ذلك أن تعلم أنك قد ربحت عمل المسيء، لأنه قد أهدى إليك حسناته في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. أما موقفك من الأذى الواقع عليك، فيلزمك فيه ملاحظة أمرين، الأول شهود نعمة الله عليك بالتكفير عن خطاياك، فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا يجب أن تنظر إلى مرارة الدواء ولا من كان الدواء على يديه، ولكن انظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نَفْعُك بمضرته، فتعلم عند ذاك أنه خير لك أن تكون مظلوماً تترقب النصر من أن تكون ظالماً تترقب الأخذ والمقت. الثاني، أن تعلم أن كل مصيبة دون الدين عافية، وما من محنة إلا وفوقها ما هو أقسى منها وأَمَرّ إلا محنة الإيمان، وما دام إيمانك لم يخالطه سوء فأنت في جوهر العافية بل قمتها. أما موقفك مع من أوقع بك الأذى، فيعينك عليه التغافل وترك المقابلة أو ترك ما تهوى من الانتقام لما تخشى من حساب الآخرة، ويحصل لك ذلك عندما تقارن بين الأذى الواقع عليك من الغير، ولا يتعدى في طبيعته أمور الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، وبين الأذى الذي ينالك من نفسك في استرسالك مع شهواتها، فإنه مضيع لآخرتك، ويتم لك النجاح في هذه المقايسة باستحضار خصلتين لازمتين لكل مؤمن، الصدق في المجاهدة، والعدل مع الله فيمن تبغض وتحب”(صلاح شادى، تأملات فى كتاب مدارج السالكين).
تطبيقات عملية:
- درب نفسك على كظم الغيظ. وسعة الصدر.
- قيم نفسك فى مدى الالتزام بخلق الإيثار.
 موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org

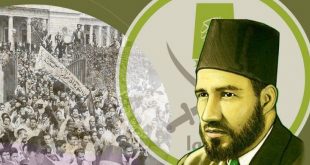



جزيتم كل الخير