الدرس الأول : ولا تنازعوا فتفشلوا “الجزء الأول”
5 أبريل، 2016
إسلاميات, تربوى
1,187 زيارة
الافتتاحية: الآيتان46-47 من سورة الأنفال
قال تعالي: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال:46-47).
ركز أبو حيان التوحيدي رحمه الله علي حكمة أمر الله بالذكر في هذا الموطن، كما ركز علي خطورة التنازع وآثاره الكارثية فقال: “أَمَرَ الله تعالي عباده المجاهدين بِذِكْرِهِ تَعَالَى كَثِيرًا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيمِ مِنْ مُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ وَالتَّلَاحُمِ بِالرِّمَاحِ وَبِالسُّيُوفِ، وَهِيَ حَالَةٌ يَقَعُ فِيهَا الذُّهُولُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَأُمِرُوا بِذِكْرِ اللَّهِ إِذْ هُوَ تَعَالَى الَّذِي يُفْزَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَيُسْتَأْنَسُ بِذِكْرِهِ وَيُسْتَنْصَرُ بِدُعَائِهِ، وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ التَّعَلُّقِ بِاللَّهِ ذَكَرَهُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُذْهَلُ فِيهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَغِيبُ فِيهَا الْحِسُّ ﴿أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾
قَالَ قَتَادَةُ: افْتَرَضَ اللَّهُ ذِكْرَهُ أَشْغَلَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ عِنْدَ الضِّرَابِ وَالسُّيُوفِ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ لَا يَفْتُرَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَشْغَلَ مَا يَكُونُ قَلْبًا وَأَكْثَرَ مَا يَكُونُ هَمًّا وَأَنْ يَكُونَ نَفْسُهُ مُجْتَمِعَةً لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَزِّعَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ الثَّبَاتَ وَذِكْرَ اللَّهِ سَبَبَا الْفَلَاحِ وَهُوَ الظَّفَرُ بِالْعَدُوِّ فِي الدُّنْيَا وَالْفَوْزُ فِي الْآخِرَةِ بِالثَّوَابِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: لَوْ رُخِّصَ تَرْكُ الذِّكْرِ لَرُخِّصَ فِي الْحَرْبِ حَيْثُ أُمِرَ بِالصَّمْتِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ تَعَالَى بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّنَازُعِ وَهُوَ تَجَاذُبُ الْآرَاءِ وَافْتِرَاقُهَا لِأَنَّهُ يَتَسَبَّبُ عَنِ التَّنَازُعِ الْفَشَلُ وَهُوَ الْخَوَرُ وَالْجُبْنُ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَذَهَابُ الدَّوْلَةِ.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الرِّيحُ الدّولة، يقال: هَبَّتْ رِيَاحُ فُلَانٍ إِذَا دَالَتْ لَهُ الدَّوْلَةُ وَنَفَذَ أَمْرُه وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ إِنَّ الرِّيحَ هِيَ الدَّوْلَة وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ مَعْنَاهُ ذهاب الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُم وَقَالَ مُقَاتِلٌ رِيحُكُمْ حِدَّتُكُمْ، وَقَالَ عَطَاءٌ جَلَدُكُمْ، وَحَكَى التَّبْرِيزِيُّ هَيْبَتُكُم”(البحر المحيط، بتصرف).
والخلاصة أن التنازع يضعف العزم، ويوهي الصف، ويبدد الجهود، ويبعثر القوي، ويذهب الهيبة، ويضيع الوقار، ويجرئ العدو، ويصرف المحب، ويمنع معونة الصديق.
وقد ركز الشهيد سيد قطب في تفسير الآيتين علي العوامل التي تؤدي إلي تحقيق النصر وهي الثبات والذكر والصبر وتجنب الشقاق والرياء والبغي.
فقال رحمه الله: “هذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو، والاتصال بالله بالذكر، والطاعة لله والرسول، وتجنب النزاع والشقاق، والصبر على تكاليف المعركة، والحذر من البطر والرئاء والبغي.
فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأثبت الفريقين أغلبهما. وما يُدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون، وأنه يألم كما يألمون، ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه، وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار، وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصربينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها، ولا حياة له سواها؟.
وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة، وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى: إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة بالله الذي ينصر أولياءه. وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها، فهي معركة لله، لتقرير ألوهيته في الأرض، وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية، وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا، لا للسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.
وأما طاعة الله ورسوله، فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: ﴿وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه، وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم- مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة- فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها، وإنما هو وضع «الذات» في كفة، والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء. ومن ثم كان هذا الأمر بطاعة الله ورسوله عند المعركة. إنه من عمليات «الضبط» التي لا بد منها في المعركة. إنها طاعة القيادة العليا فيها، التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها. وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله، ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا. والمسافة كبيرة كبيرة.
وأما الصبر: فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة أية معركة في ميدان النفس أم في ميدان القتال. ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح”(في ظلال القرآن، بتصرف).
دروس مستفادة من الآيتين الكريمتين:
• من عوامل النصر الثبات والذكر وترك النزاع والشقاق وتجنب الرياء والبغي.
• النزاع والشقاق يؤديان إلي الفشل والهزيمة وذهاب الريح وانفراط العقد وضياع الدولة والسلطة والهيبة والمكانة وشماتة الأعداء.
• ……………………..أذكر دروساً أخري.
الجماعة رحمة والفرقة عذاب:
امتن الله تعالي علي المؤمنين بنعمة الأخوة في الله وتأليف قلوبهم وجمع كلمتهم فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾(آل عمران: 102، 103). كما حذر سبحانه عباده المؤمنين من التنازع والفرقة فقال: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(آل عمران: الآية 105 (وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: الآية 159). ودعا الله المؤمنين إلي تحكيمه سبحانه وتحكيم رسوله عند التنازع أي تحكيم القرآن والسنة. فقال تعالى:﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: الآية 56(. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾(النور: الآية 51).
وفي السنة المطهرة تحذير من الفرقة علي نحو ما وقع في بني إسرائيل؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» (رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم)
وقد أخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أن أمته ليست معصومة من أسباب التنازع؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلاً ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» (رواه مسلم).
ولهذا فقد أرشدنا صلي الله عليه وسلم إلي بعض الوسائل العملية التي تمنع التنازع وتحسمه إذا وقع:
ومنها النهي عن كثرة الخلاف، فإن ذلك يفضي إلي النزاع و الشقاق؛فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم واختلافُهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(رواه البخاري ومسلم).
ومنها تعميق روح الحب و الأخوة والتسامح والتغافر. قال صلي الله عيه وسلم: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» (رواه مسلم)، و قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» (رواه أبو داود) وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه» (متفق عليه) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(متفق عليه) وقال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين، حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا» (رواه مسلم).
نماذج تاريخية للتنازع المفضي للفشل:
التاريخ مخزن التجارب الإنسانية. يقول ابن مسكويه: “وإنّى لمّا تصفّحت أخبار الأمم، وسير الملوك، وقرأت أخبار البلدان، وكتب التواريخ، وجدت فيها ما تستفاد منه تجربة لا تزال يتكرّر مثلها وينتظر حدوث شبهها وشكلها: كذكر مبادئ الدول، ونشأة الممالك، وذكر دخول الخلل فيها بعد ذلك، وتلافى من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال، وإغفال من أغفله إلى أن تأدّى إلى الاضمحلال والزوال”(تجارب الأمم).
وفي صحائف التاريخ ما يؤكد أن التنازع فشل وبوار واضمحلال، كما أنه ضيعة للأعمار وخيبة للأمال، وفيما يلي نقص عليك من صحائف التاريخ ما ينطق بذلك بأفصح لسان وأوضح بيان:
• محو الإمبراطورية الفارسية:
فقد أدي التنازع والصراع الدامي علي العرش مع غيره من العوامل الأخري من الظلم والقهر والفساد إلي محو الإمبراطورية الفارسية من الوجود بعد قرون من السيادة علي نصف الكرة الأرضية،
• تفتيت الإمبراطورية اليونانية:
سواء في المرحلة الهيلينية التي تسبق الإسكندر الأكبر أو في المرحلة الهلينستية التي تبدأ به؛ ففي المرحلة الأولي تفتتت الإمبراطورية عقب الصراع الدامي بين أثينا وإسبرطة والذي تجلي في حرب تشبه الحرب العالمية تسمي حرب البلبيونيز، وكذلك في المرحلة الهلينستية كان الصراع بين خلفاء الإسكندر سبباً في تفتيت امبراطوريته الواسعة التي حكمت الأرض كلها إذ لم تدم وحدتها أكثر من اثني عشر عاماً، وكان التنازع والصراع هو السبب المباشر في تفتيتها مع توفر القوة العسكرية والعتاد والثروة وكانت الإمبراطورية ما تزال في شبابها وعنفوانها” فاختص أنتباتر بمقدونية وبلاد اليونان؛ وليسماخوس بتراقية، وأنتجونس بآسية الصغرى، وسلوقس ببابل، وبطليموس بمصر”. (ويل ديورانت، قصة الحضارة).
• تقويض الإمبراطورية الرومانية:
أدي التنازع والصراع إلي انقسام الإمبراطورية الرومانية إلي نصفين كبيرين هما الإمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالدولة البيزنطية وهي التي جاء الإسلام فورث أرضها بداية من فتح الشام بعد موقعة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم فتح مصر علي يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وانتهاء بفتح عاصمتها القسطنطينية علي يد محمد الفاتح رحمه الله. أما نصفها الثاني فهو الدولة الرومانية الغربية وعاصمتها روما فقد ضربتها الخلافات ودارت بينها حروب طاحنة في فترات كثيرة انتهت بنموذج الدولة القطرية المعروفة حاليا بعد معاهدة وستفاليا التي أعقبت الحروب الدينية في أوروبا. وعن أسباب انهيار الحضارة الرومانية يقول ويل ديورانت: “الحضارة العظيمة لا يقضى عليها من الخارج إلا بعد أن تقضي هي على نفسها من الداخل. وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب الجوهرية لسقوط روما في شعب روما نفسه، أي في أخلاقها، وفي النزاع بين طبقاتها، وفي كساد تجارتها، وفي حكومتها الاستبدادية البيروقراطية، وفي ضرائبها الفادحة الخانقة وحروبها المهلكة” (قصة الحضارة).
• طرد الإسلام من الأندلس:
بعد ثمانية قرون من المجد والسيادة بسبب التنازع والصراع بين ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس بسقوط الدولة العامرية وتفتت وحدة الاندلس واقتسام أراضيها بين ملوك الطوائف ضعاف العقول صغار الهمم، وقد وصفهم ابن الخطيب بقوله: “ليس لأحدهم في الخلافة إرث، ولا في الإمارة سبب، ولا في الفروسية نسب، ولا في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطار، واقتسموا المدائن الكبار، وجندوا الجنود، وقدموا القضاة، وانتحلوا الألقاب، وكتبت عنهم الكتاب الأعلام، وأنشدهم الشعراء، ودونت بأسمائهم الدواوين” وقد تندر الشاعر أبو الحسن القيرواني بهؤلاء وألقابهم فقال:
مما يزهدني في أرض أندلس ***** ألقاب معتصم فيها ومعتضــــــد
ألقاب مملكة في غير موضعها ***** كالهر يحكي انتفاخاً صَوْلة الأسد
يقول الشيخ الغزالي: “لخص لي أحد المرشدين السياحيين تاريخ الإسلام بالأندلس في سطر واحد قال: قامت للمسلمين هنا دولة لما كانوا لله خلائف، وطردوا من هنا لما أصبحوا علي ثراها طوائف”. وقد “أفضت المنازعات والفتن إلى استعانة الأطراف بأمراء وملوك الممالك الإسبانية الشمالية مقابل التنازل عن بعض الحصون والمدن الحدودية المهمة، فقد منحت مثل هذه الحصون من قبل المتنازعين مقابل مئات من جنود هذه الممالك كانوا يقاتلون مع هذا الطرف أو ذاك ضد الطرف الآخر، وخلال فترة النزاع الذي أشرنا إليه سابقاً تنازل المتخاصمون عن حصن غرماج، وأوسمة، وغيرها من المناطق المهمة التي بذلت الدولة في عهد الناصر والمنصور ابن أبي عامر جهوداً استثنائية في السيطرة والمحافظة عليها، لأنها نقاط استراتيجية للجيوش العربية المتقدمة باتجاه الممالك الإسبانية الشمالية.( خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس). وقد كان هذا التنازع سببا للهزيمة العسكرية والسياسية التي أعقبها محو الإسلام من الأندلس بإجبار المسلمين علي اعتناق المسيحية وتغيير أسمائهم العربية وطمس كل مظاهر الحضارة الإسلامية بالتدريج، يقول محمد عبد الله عنان: “أضحت الأندلس في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري، تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش: منظر الصرح الشامخ، الذي انهارت أسسه، وتصدع بنيانه، وقد اقتصت أطرافها، وتناثرت أشلاؤها، وتعددت الرياسات في أنحائها، لا تربطها رابطة، ولا تجمع كلمتها مصلحة مشتركة؛ لكن تفرق بينها بالعكس منافسات وأطماع شخصية وضيعة، وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة، والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها وقواها القديمة تباعاً، ويحدق بها خطر الفناء من كل صوب… ونستطيع القول بأن تمزق الأندلس على هذا النحو، كان ضربة، لم تنهض الأندلس من آثارها قط، بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذي لبثت تتقلب فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى. وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيقي لم يطل أكثر من سبعين عاماً، وبالرغم من أن الأندلس، قد التأم شملها بعد ذلك في ظل المرابطين ثم الموحدين من بعدهم، وبالرغم من أنها استطاعت أن تسترد تفوقها العسكري القديم في شبه الجزيرة الإسبانية في فترات قصيرة: بالرغم من ذلك كله، فإن الأندلس لم تستطع أن تسترد وحدتها الإقليمية القديمة، ولا تماسكها القديم قط، بل لبثت بالعكس، خلال صراعها الطويل مع إسبانيا النصرانية، تفقد قواها ومواردها تباعاً، وتنكمش رقعتها الإقليمية تدريجياً. حتى إذا كان منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)، رأينا رقعة الوطن الأندلسي، ترتد إلى ما وراء نهر الوادي الكبير، وتنحصر في مملكة غرناطة الصغيرة، ورأينا قواعد الأندلس القديمة الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وغيرها، تغدو مدناً إسبانية نصرانية، ويغدو ميزان القوى في شبه الجزيرة الإسبانية بيد مملكة قشتالة الكبرى وكان سقوط غرناطة فى يد إسبانيا النصرانية فى سنة 897 هـ (1492م)، نذيراً بانهيار صرح الأمة الأندلسية القومى والاجتماعى، وتبدد تراثها الفكرى والأدبى، وكانت إسبانيا النصرانية ترمى قبل كل شىء إلى القضاء على خواص الأمة المغلوبة الدينية والفكرية، وعلى سائر الروابط الأدبية التى تربطها بماضيها المجيد؛ وقد نجحت السياسة الإسبانية، يدعمها طغيان الكنيسة وعسف ديوان التحقيق، فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد، فلم يمض على سقوط غرناطة نحو خمسين عاماً، حتى استحالت بقية الأمة الأندلسية إلى شعب جديد، يستبدل دينه القديم -الإسلام- بالنصرانية المفروضة، ويتكلم القشتالية، وتغيض البقية الباقية من خصائصه القديمة، شيئاً فشيئاً، تحت ضغط التشريعات والإجراءات التعسفية المرهقة” (محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، بتصرف).
• تفتيت وحدة المغرب الأقصي:
وسقوط دوله واحدة تلو الاخري بسبب النزاعات المستمرة والصراع علي السلطة؛ فمن أسباب سقوط دولة بني مرين في المغرب الأقصي: “دخول بني مرين في صراع عنيف مع دويلات المغرب الأوسط والأدنى، كلفها الاموال والرجال والعتاد والأوقات، وكان قتال بني العقيدة الواحدة والدين الواحد مما ساهم في إضعاف الشمال الأفريقي كله والتعجيل بسقوط دولة بني مرين، ومن أسباب سقوط الدولة الوطاسية: دخولهم في معاهدات مع النصارى المحتلين من الأسبان والبرتغاليين، من أجل مصالحهم وسلطتهم ونفوذهم، وعجزهم عن الوقوف بجانب المسلمين فى الأندلس والدفاع عنهم وحمايتهم، والتفكك السياسي بسبب الحروب الداخلية الطاحنة بين المغاربة. وبعد وفاة أحمد المنصور الذهبي في عام 1012هـ/1603م دخل المغرب في حالة من الضعف والتفكك آل به الأمر الى سقوط الدولة السعدية وقد كان لذلك السقوط عدة عوامل منها:الصراع المرير على كرسي الحكم بين أبناء الأسرة السعدية مما عجل بنهاية الاسرة سريعاً وانهيارها. وقد ساهم ذلك الصراع في قيام الثورات والحركات الانفصالية والامارات المستقلة عن الحكومة المركزية في المغرب الاقصى وانشغل الأمراء السعديين بالصراع فيما بينهم عن أحوال الرعية والعدو الخارجي… ومن أسباب انهيار الدولة الحفصية: الصراع الداخلي على الحكم بين أبناء البيت الحفصي، وما ترتب على ذلك من صراع عنيف وقتال دموي، فكان سقوط دولة الحفصيين نتيجة طبيعية لما آلت إليه بسبب التنازع بين المسلمين وعدم حرصهم على سلامة وحدة الأمة وأهدافها العظمى”(الصلابي، دولة الموحدين، بتصرف). ومن أسباب سقوط دولة المرابطين التي وحدت المغرب الأقصي وامتد سلطانها إلي الأندلس: “انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراثى الذى سبب نزاعًا عنيفًا على منصب ولاية العهد بين أولاد على بن يوسف، كما تطلع مجموعة مِن الأمراء إلى منصب الأمير على ونازعوه فى سلطانه مما سبب تمزقًا داخليًا، ففقدت الدولة المرابطية وحدتها الأولى، وكثرت الجيوب الداخلية فى كيان الدولة، وتفجرت ثورات عنيفة فى قرطبة، وفى فاس وغيرهما ساهمت فى إضعاف الوحدة السياسية وإسقاط هيبة الدولة المرابطية”(دولة المرابطين).
• اندثار الدولة الخوارزمية:
يرجع الصلابي ذلك إلي أسباب عديدة منها: “فشل الدولة الخوارزمية في إيجاد تيار حضاري، وكره الشعب لنظام الحكم وعدم ولائه له، والنزاع الداخلي في الأسرة الحاكمة وضعف النظام الحربي، وحب الدنيا وكراهية الموت، وترك الاتحاد والوقوع في ظلم العباد، وأنانية محمد علاء الدين الخوارزمي وهزيمته النفسية، وشخصية جلال الدين منكبرتي، وقصر نظر الخليفة العباسي الناصر لدين الله”(الصلابي، المغول والتتار بين الانتشار والانكسار).
• زوال الخلافة الأموية:
بعد عرضه لتاريخ الخلافة الأموية يقول الصلابي: “إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية أن نتوقى الهلاك بتوقي أسباب الاختلاف المذموم، لأن الاختلاف كان سبباً من الأسباب في ضياع الدولة الأموية وهلاكها واندثارها وكان لهذا الاختلاف الذي وقع في البيت الأموي أسبابه منها ضعف الوازع الديني عند بعض أمراء الأمويين، والأنانية وحب الذات، والتكالب على المصالح الدنيوية، والتناحر من أجلها والحرص على السلطان والجاه والمناصب، وتحكيم بعض الخلفاء أهواءهم في الأمور فهذه الأسباب كانت وقوداً للمنازعات والخلافات التي وقعت بين أفراد البيت الأموي، فكانت من أكبر معاول الهدم وأسباب الضعف وتلاشي الدولة وقد استقرأ هذه الحقيقة ابن خلدون حيث ذكر أن من آثار الهرم في الدولة انقسامها وأن التنازع بين القرابة يقلص نطاقها كما يؤدي إلى قسمتها ثم اضمحلالها”(الصلابي، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار).
• انهيار الخلافة العباسية:
حيث كان الصراع الداخلي أحد هذه الأسباب التي أدت إلي انهيار الخلافة العباسية بعد قرون من الحكم. يقول الصلابي: “من أهم أسباب زوال الدولة العباسية؛ غياب القيادة الحكيمة، وإهمال فريضة الجهاد، وانعدام الوحدة السياسية، وضعف الجيش العباسي، وضعف عصبية الدولة، وضعف قيمة العهود، وضعف همم ملوك الأطراف، وتنازلات سياسية دلت على الوهن العباسي، وتعدد مراكز القوى واحتلال خطوط الدفاع الأولى، وإبعاد الكفاءات النادرة ومنافسة العلويين، والترف والوصول إلى آخر نقطة من الانحلال والتدهور، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصراع الداخلي في بغداد وخيانات الشيعة”(الصلابي، المغول والتتار بين الانتشار والانكسار).
تطبيقات عملية:
1. في التاريخ الحديث للأمم والجماعات أمثلة أخرى علي أثر التنازع في الفشل والضعف – اذكر نماذج لها
2. حدد أهم ثلاث ممارسات تؤدى إلي التنازع من وجهة نظرك- دلل علي ذلك وناقشه في اللقاء القادم
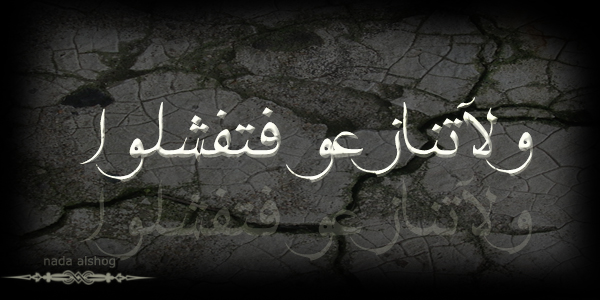
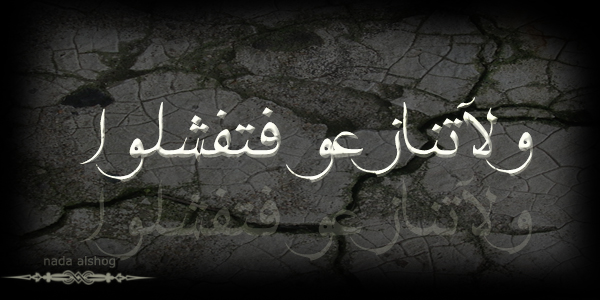
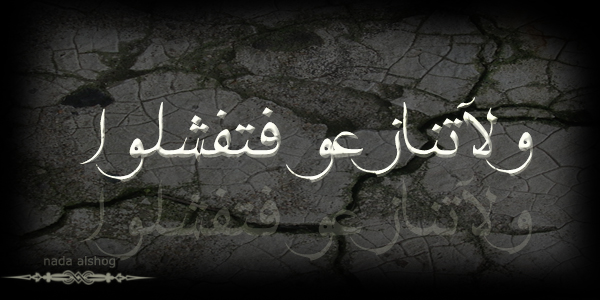
 موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org